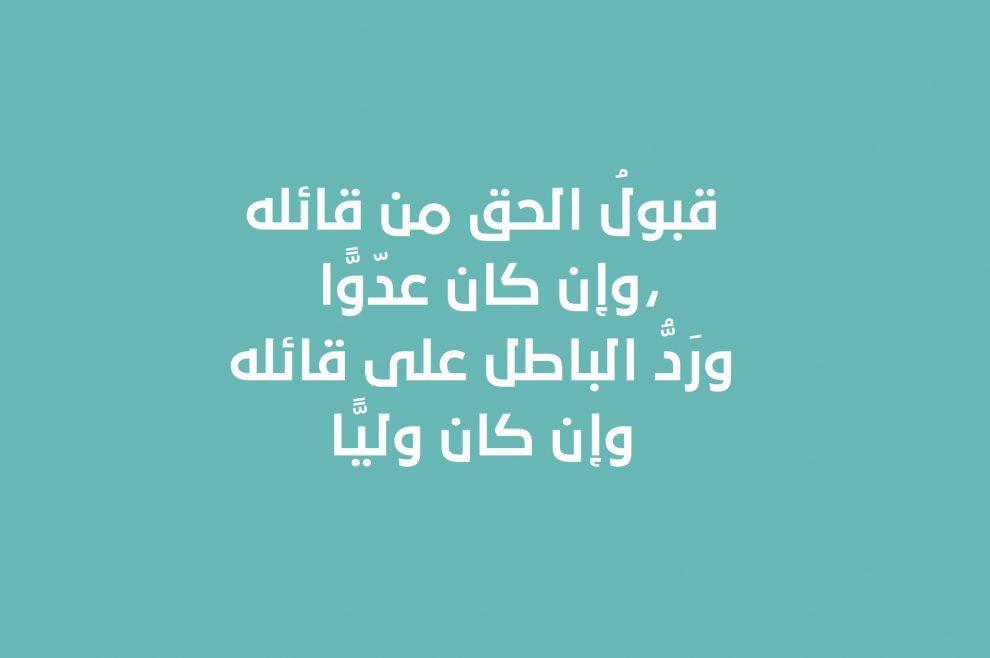قبولُ الحق من قائله وإن كان عدّوًّا، ورَدُّ الباطل على قائله وإن كان وليًّا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهُ والاه، أما بعد:
فالحق له حلاوة تجذب إليها النفوس الأبيّة والهمم العَليَّة، وللباطل مرارة ووحشة تنْفرُ منهما القلوب الزكية، يقول الله تعالى: ﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ﴾ ويقول سبحانه وتعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ فالحق أولى بالقبول والتعظيم دون النظر إلى قائله، طالما أنه حق في الحال والمآل، والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لما أخبره أبو هريرة – رضي الله عنه – بما قاله الشيطان له في فضل قراءة آية الكرسي، قال له: “صَدَقَكَ، وهو كذوب” رواه البخاري برقم (2311) من حديث أبي هريرة، وليس هناك أفْسَد وأشرّ من الشيطان، أعاذنا الله من شياطين الإنس والجن، ومع ذلك لم يَرُدَّ الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كلمة الحق منه، لكونها صَدَرَتْ من عَدُوٍّ لله – جل وعلا – وأوليائه عبر التاريخ.
وكذلك لما أَتَى يهودي إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فقال: إنكم تُنَدِّدون، إنكم تُشْرِكون، تقولون: ما شاء الله وشِئْتَ، وتقولون: والكعبة؛ فأمرهم النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إذا أرادوا أن يَحْلِفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت” انظر “صحيح سنن النسائي” لشيخنا الألباني – رحمه الله – برقم (3773)، ولم يَقُلْ – صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: اليهود أعداء لنا، ما يريدون لنا الخير، فلا نبالي بكلامهم؛ لأنهم – فقط – يبحثون عن الزلات، ويكتمون الحسنات، بل أمر أصحابه – رضي الله عنهم – بإصلاح كلماتهم، وأما نيّة اليهودي السيئة فعلى نفسه، وأما الحق من كلامه فيُقْبَل لكونه حقًّا.
وأخبار أهل الكتاب من بني إسرائيل يجوز حكايتها عند عدد من نُقّاد أئمة الحديث، إذا لم تكن باطلة، فإن وافقت ما جاء في السنة؛ فنصدقها، وإن خالفت ما في ديننا رددناها، وإن لم يكن هذا ولا ذاك، فتُرْوَى، ولا نُصَدِّقها ولا نُكَذِّبها.
وقد ذكر الغزالي في “إحياء علوم الدين” لو أن بوَّابًا على باب مَلِكٍ، وعنده زعارة في خلُقه، ويتكلم على الواقفين بباب الملك للدخول عليه، فإذا كان ثوب أحدهم قد علِقَت به نجاسة، ورفع البوّاب صوته مُنْكِرًا عليه، مستخدمًا لعبارات قاسية، فإذا قال الرجل: دَعْك من قول هذا البوّاب الفظّ الغليظ، ودخل على الملك بحالته القذرة؛ فلربّما تعرَّض لسخط الملك وأذيّته، وإذا أخذ الحق من كلام البوّاب، وغسل ثوبه مما علق به، وترك نية البواب وأسلوبه؛ فلعلّه يظفر برضى الملك وقضاء حاجته منه، فالعاقل من يقبل الحق دون النظر إلى قائله، والله أعلم.
وهذه أقوال لبعض علماء السنة، تدل على النظر إلى القول ودليله، لا إلى قائله وقبيله الذي ينتمي إليه فيُقْبَل من الأقوال ما كان حقًّا، ويُرَدُّ منها ما كان باطلا، فالحق ضالة المؤمن، أينما وجدها أخَذَها:
[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في “منهاج السنة” (2/342-343): “واللهُ قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني – فضلاً عن رافضي – قولاً فيه حق؛ أن نتركه، أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحق…..” إلى أن قال – رحمه الله -: “ويَرَوْنَ – أي أهل الكلام والبدع – أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدَع، الذين يردون باطلاً بباطل، وبدعة ببدعة، ويأمرون – أي أهل السنة – ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال، وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله، ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه، لكن بيّنّا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال؛ ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك…… ” إلى آخر ما قاله -رحمه الله-.
فتأمل أخي القارئ نقْل هذا الإمام عن أئمة السنة والسلف قبولهم الحق من أي رجل كان، فهل تجد بعد ذلك ارتيابًا في أن منهج أئمة السلف في هذا الأمر على خلاف ما عليه كثير ممن ينتمون إلى السلفية اليوم، وهم بين إفراط وتفريط، فإن أحبُّوا رجلاً أخذوا قوله كله – بل تعصَّبوا له – وضيّعوا في سبيل ذلك حقوق الآخرين المخالفين لهم من أهل الهدى والسداد، وإذا كرهوا رجلاً – وقد يكونون ظالمين له في كراهيتهم إياه – ردُّوا كل ما يقول، وغاصُوا في نيته وضميره وقصْده، وقالوا: لا تُصَدِّقوه وإن قال هذا القول؛ فما يريد من وراء ذلك إلا إفساد الدين، والتمويه والتضليل … إلى غير ذلك من التقوّل على عباد الله بغير علْم ولا هُدًى ولا كتاب منير!!
وإذا كانوا كذلك فلا تغترّ بقولهم: نحن نتبع الدليل، ولا نتعصب للرجال، وكل يُؤْخذ من قوله ويُرَدّ إلا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فو الله لقد رأينا من حال بعضهم حزْبيّة وعصبيّة أشد مما ينكرونه على المخالفين من حزبيات، وأما نحن فنرد التعصب والتحزب المخالفيْن للحق من هؤلاء وأولئك، ونسأل الله البصيرة والثبات على الحق حتى الممات.
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – أيضًا في (13/77) من “المنهاج”: “ونحن إنما نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلاً، وأما الحق؛ فعلينا أن نَقْبَلَه من كل قائل…..” اهـ .
.. وفي “مجموع الفتاوى” (10/82) ذكر – رحمه الله – بعض شطحات الصوفية، والمراد بالصوفية في هذا المقام الذين اشتغلوا برياضة نفوسهم وتهذيبها، ولم يسلكوا في ذلك المسلك الصافي الذي كان عليه الصحابة وأئمة السلف، بل بعضهم وصل به الأمر أن قال بمقالة الاتحادية!!! فضلّوا في ذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعا، وليس الكلام هنا على الصوفية القبورية الوثنية – فذكر – رحمه الله – أن الناس فيهم ثلاثة أصناف: صِنْفٌ ردُّوا كل ما عندهم من حق وباطل، وصِنْف قَبِلُوا كل ما عندهم، والصِّنْف الثالث فصَّلوا في أمرهم، ثم قال – رحمه الله -: “والصواب: إنما هو الإقرار بما فيها – أي في طريقتهم وأقوالهم – وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة…..” اهـ. وانظر ما قاله أيضًا – رحمه الله – في الاستقامة” (1/115-404،201،116)، و “مجموع الفتاوى” (13/95-96).
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله – في “الحموية” (ص153): “ولْيَعْلَم السائل: أن الغرض من هذا الجواب: ذِكْرُ ألفاظ بعض أئمة العلماء، الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل مَنْ ذَكَرْنا شيئًا من قوله من المتكلمين وغيرهم؛ نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يُقْبَلُ مِنْ كل مَنْ تَكَلَّم به….” اهـ.
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله أيضًا – كما في “مجموع الفتاوى” (10/82): (والصواب: الإقرار بما فيها -يعني طريقة بعض المنتسبين للتصوف- وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة…).اﻫ
[2] وقال الإمام ابن القيم – رحمة الله عليه – في “مدارج السالكين” (2/39-40) بعد أن ذكر بعض شطحات المخالفين: “وهذه الشطحات أَوْجَبَتْ فتنة على طائفتين من الناس: إحداهما حُجِبَتْ بها عن محاسن هذه الطائفة، ولُطْفِ نفوسهم، وصِدْقِ معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بهم مطلقًا، وهذا عدوان وإسراف، فلو كان كل من أخطأ أو غلط، تُرِكَ جملة، وأُهْدِرَتْ محاسنه؛ لفسدت العلوم والصناعات والحِكم، وتعطلت معالمها ….ثم ذكر الطائفة التي قَبِلَتْ كل ما عند المخالفين، وسماهم معتدين مُفَرِّطين، ثم قال: والطائفة الثالثة: وهم أهل العدل والإنصاف، والذين أعطَوْا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي منْزلة منْزلته، فلم يَحْكُمُوا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يُقْبَل، وردوا ما يُرَدُّ…..اهـ.
وفي “الصواعق المرسلة” (2/515-519) قال – رحمه الله -: “الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل، وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذموم: الاختلاف في كتاب الله نوعان:
أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، وهم الذين اختلفوا بالتأويل، وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ وهم الذين تَسْوَدُّ وجوههم يوم القيامة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد، وهذا النوع هو الذي وَصَفَ الله أهله بالبغي، وهو الذي يُوجِبُ الفُرْقَة والاختلاف، وفسادَ ذات البين، ويُوقِعَ التحزُّب والتباين.
والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم، فمن أصاب الحق؛ فهو محمود، ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه؛ فاسْمُ الذم موضوعٌ عنه، وهو محمود في اجتهاده، مَعْفُوٌّ عن خطئه، وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه؛ فهو مذموم.
ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ وقال تعالى: ﴿ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.
والاختلاف المذموم: كثيرا ما يكون مع كل فِرْقَةٍ من أهله بعض الحق، فلا يُقِرُّ له خصمه به، بل يجحده إياه بغْيًا ومنافسة، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه، وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف أهل الحق، فإنهم (يقبلون) الحق من كل من جاء به، فيأخذون حق جميع الطوائف، ويردون باطلهم، فهؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اخْتَلَفَ فيه المختلفون، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول في دعائه: “اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اخْتُلِفَ فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم“.
فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان، ومع من كان – ولو كان مع من يُبْغضه ويعاديه -، وردّ الباطل مع من كان – ولو كان مع من يحبه ويواليه – فهو ممن هُدِيَ لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحق، فهذا أعْلَمُ الناس وأهداهم سبيلا، وأقْوَمُهم قيلا، وأهْلُ هذا المسلك إذا اختلفوا؛ فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى، يُقِرُّ بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظُر، الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم، بالتناظر والتشاور، وإعمالهم الرأْيَ، وإجالتهم الفِكْرَ في الأسباب الموصلة إلى دَرَكِ الصواب، فيأتي كل منهم بما قَدَحَهُ زِنادُ فِكْرِه، وأَدْرَكه قوة بصيرته، فإذا قُوبِل بين الآراء المختلفة، والأقاويل المتباينة، وعُرضت على الحاكم الذي لا يَجُور، وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتَجَرَّد الناظر عن التعصب والحَمِيّة، واستفرغ وُسْعَه، وقَصَدَ طاعة الله ورسوله؛ فَقَلَّ أن يخفى عليه الصوابُ من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه، والخطأُ وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، والخطأ وما هو أقرب إليه، ومراتب القُرْب والبُعْد متفاوتة.
وهذا النوع من الاختلاف لا يُوجِبُ معاداة، ولا افتراقا في الكلمة، ولا تبديدا للشمل؛ فإن الصحابة – رضي الله عنهم – اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع: كالجَدِّ مع الإخوة ….” وذكر – رحمه الله – أمثلة كثيرة لما اختلف فيه الصحابة من مسائل الفروع، ثم قال: “فلم يَنْصِب بعضهم لبعض عداوة، ولا قَطَع بينه وبينه عِصْمة، بل كانوا كل منهم يجتهد في نَصْر قوله بأقصى ما يَقْدِر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة، من غير أن يُضْمِر بعضهم لبعض ضَغْنًا، ولا ينطوي له على مَعْتَبة ولا ذم، بل يَدُلُّ المستفتي عليه مع مخالفته له، ويَشْهَدُ له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق.
وهنا نوع آخر من الاختلاف، وهو وفاق في الحقيقة، وهو اختلاف في الاختيار والأَوْلَى، بعد الاتفاق على جواز الجميع، كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة …..” وذكر – رحمه الله – أمثلة لذلك، ثم قال: “فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف؛ فهو اتفاق في الحقيقة”.
ثم قال – رحمه الله -: “فصل: ووقوع الاختلاف بين الناس أَمْرٌ ضروري لا بُدَّ منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقُوَى إدراكهم، ولكن المذموم بَغِيُ بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قَصْدُه طاعة الله ورسوله؛ لم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدا، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة؛ لم يَكَدْ يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بَنَوْا عليه واحدٌ، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقَصْدَ واحدٌ، وهو طاعة الله ورسوله، والطريقَ واحدٌ، وهو النظر في أدلة القرآن والسنة، وتقديمها على كل قول ورَأْيٍ وقياس وذَوْقٍ وسياسة” اهـ.
وقال الإمام ابن القيم في “طريق الهجرتين” (ص: 386-387): “ولولا أن المقصود ذِكْرُ الطبقات؛ لذكَرْنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبيَّنَّا تناقض أهلها، وما وافقوا فيه الحق، وما خالفوه، بالعلم والعدل، لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها؛ معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق، ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق؛ فقد فُتح له من العلم والدين كل باب، ويُسِّرَ عليه فيهما الأسباب، والله المستعان” اهـ .
وصَدَقَ الإمام ابن القيم – رحمه الله – فيما قال، فلقد رأينا البؤس والشقاء في أحوال من لم يفتح الله له بهذه الطريق؛ فأَلْقَتْ بهم السبل إلى كل مضيق، وحُرِموا بسبب ذلك السعادة والتوفيق، الموجودَيْن في لزوم منهج أهل العلم والتحقيق – وهذا حال المتعصبين والمتحزبين لغير الحق حيثما كانوا -: فتراهم يحاربون اليوم فردًا أو طائفة، ويُشنِّعون عليهم، ويردّون كل أقوالهم، ثم ما يلْبثون أن يختلفوا فيما بينهم، ويرمي بعضهم بعضًا بأقذع الكلمات!! وهذا بسبب حرمانهم الفهم السديد، وعدم توطينهم أنفسهم على قبول الحق من قائله، وترْك باطله؛ لأنهم إما أن يقبلوا كل قوله، أو يردوه كلّه، وما من شخص أو جماعة إلا وعندهم حق وباطل، وليس بعد رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رجل معصوم في كل ما يقول، وإذا كان الشيطان قد يَصْدُق في بعض ما يقول، وهو الكذوب الذي لعنه الله، فكيف بمن هو دونه؟!
إلا أن تمييز الحق من الباطل لا يتم إلا لمن له أهلية ذلك، ولذا فأنصح – بل يجب على – كل من لا يُحْسن ذلك: أن يلزم أهل الحق الصافي، حتى تقوى شوكته، وتتسع مداركه، ويستبصر الطريق، كيْ لا ينطلي عليه باطل المنحرفين، فإذا وفّقه الله – عز وجل – ومَنَّ عليه بهذه المنزلة، وأصبح آمنًا على نفسه من الشبهات الخطّافة؛ فليجالس من شاء، أو يقرأ له – إذا كان لذلك حاجة شرعية، وأنفع للإسلام والمسلمين – فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – يقرأ لكل الطوائف، بل كان أعلم بكلام الفِرَق وأهلها من المنتمين إليها، بل حكى – رحمه الله – أنه يعرف خطّ الجن وكتابتهم، وإياك أن تغتر بنفسك، وتُحسن بها الظن، وترى أنك قد بلغت هذه الرُّتب السَّنية، وأنت لسْتَ كذلك، فتتزبَّب قبل أن تتحصرم – فتهلك مع الهالكين، وهذا حالنا، والله المستعان.
[3] وممن صرّح بقبول الحق من قائله – وإن كان منحرفًا – الحافظ الذهبي، فقد قال – رحمه الله – في “الميزان” (1/5) ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: “شيعيٌّ جَلْد، لكنه صدوق؛ فَلَنا صِدْقُهُ، وعليه بِدْعَتُهُ” اهـ ، أي نقْبل منه ما أتقن حفظه، وتثبّت في نقْله، وأما بِدْعتُه فعلى نفسه، وهكذا موقف أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن، الذين يقبلون كثيرًا من روايات أهل البدع، إذا توفَّر صِدْقهم فيما رَوَوْه، ولم يرْوُوا ما يؤيِّد بدعتهم، وروايات هؤلاء مشهورة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعجمات بما يشقُّ حَصْرها، مما يدل على أن منهج أهل السنة قائم على قبول الحق ممن كان، وردُّ الباطل على من كان، لا كحال أهل العصبية والحزبية الممقوتة، والله المستعان.
[4] وهذا المنهج قرره أيضًا العلامة السِّعْدي في تفسير سورة المائدة الآية (8) فقد قال رحمه الله – في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ “أي: لا يَحْمِلَنَّكم بُغْضُ قوم على أن لا تعدلوا، كما يفعله من لا عَدْلَ عنده ولا قِسْط، بل كما تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم؛ فاشهدوا له، ولو كان كافرًا أو مبتدعًا، فإنه يجب العدلُ فيه، وقبولُ ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق، لا لأنه قاله، ولا يُرَدُّ الحق لأجل قوله، فإن هذا ظُلْم للحق“.اﻫ من “تيسير الكريم الرحمن”.
(تنبيه): كثيرًا ما يكون الحق الموجود في كلام أهل البدع الشنيعة مشُوبًا بباطل، ممتزجًا بشبهات تزعزع الإيمان في القلوب، ولا يكاد يهتدي إلى معرفتها والتمييز بينها إلا الجهابذة – والله أعلم بضعفنا وقِلّة تحقيقنا – ففي هذه الحالة على الضعيف أن يحذر من النظر في كلامهم، وأما القوي فإن احتاج إلى أخْذ ما عندهم – بعد تمييزه – وإلا فيمكن أن يستفيد هذا الحق من غيرهم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في معرض كلامه على شطحات الحسين بن منصور الحلاج الذي قُتل في الزندقة: “وهذا الكلام المحكيّ عن الحلاج فيه ما هو باطل، وفيه ما هو مجمل محتمل، وفيه ما لا يتحصل له معنى صحيح، بل هو مضطرب، وفيه ما ليس في معناه فائدة، وفيه ما هو حق، لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن، (وأسَدُّ) وأنفع …” اهـ من “الاستقامة” (1/121).
رزقنا الله جميعًا حُبُّ الحق وإيثاره واتّباعه، وجعلنا من أهله والمنافحين عنه في السرّ والعلن، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه جَوَادٌ كريم، بَرٌّ رحيم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
24/شعبان/1439هـ